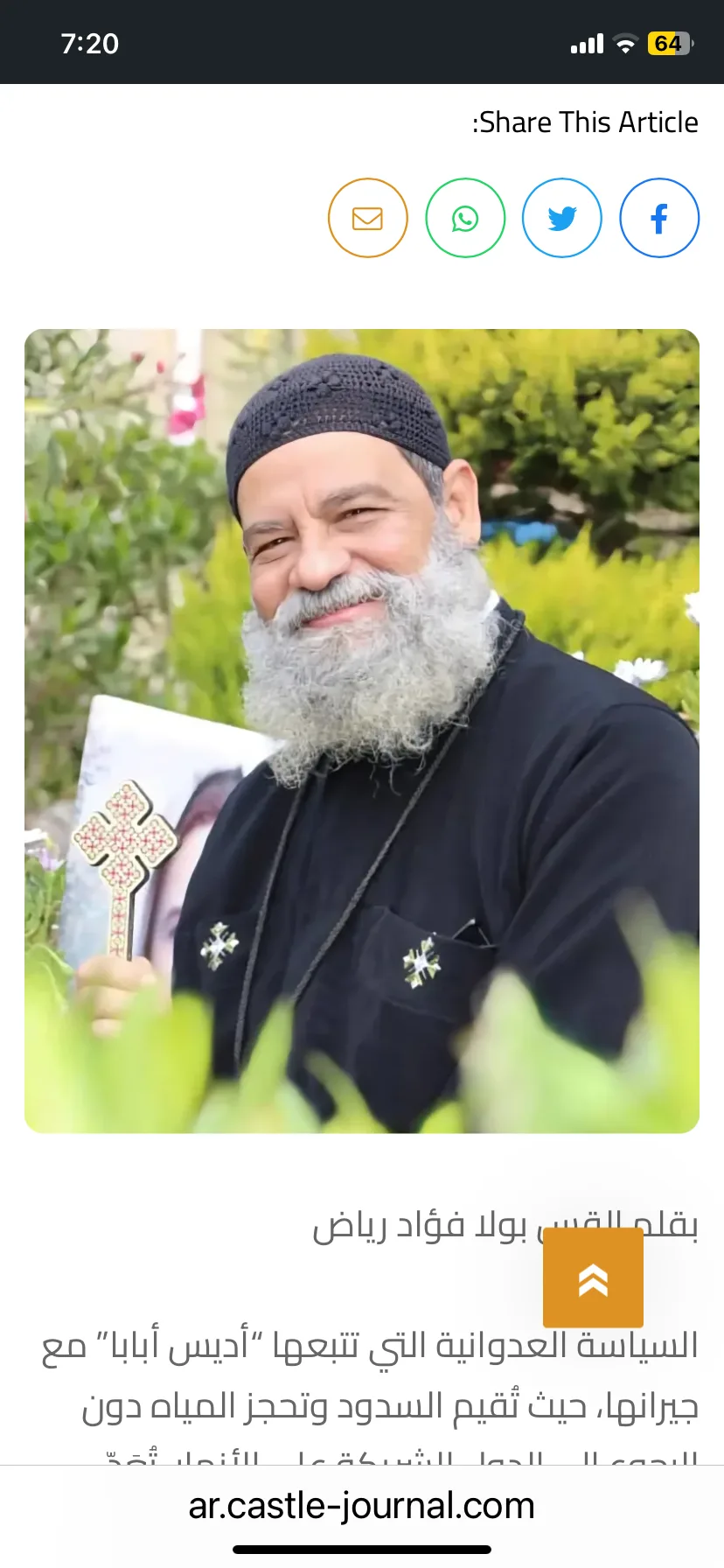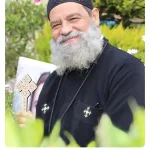بدايات النقد عند العرب القدماء: من الذوق إلى النظرية”وانطباعات فردية إلى تأملات عقلية منظمة ومذاهب نقدية ذات أسس ومفاهيم.
بقلم المستشار / أحمد المندراوي
يُعدّ النقد الأدبي عند العرب ظاهرةً فكريةً أصيلة، نشأت مع نشوء القول الشعري ذاته، وتطورت تدريجيًّا من ملاحظات ذوقية وانطباعات فردية إلى تأملات عقلية منظمة ومذاهب نقدية ذات أسس ومفاهيم.
ولم يكن النقد العربي وليد التقليد أو النقل عن الأمم الأخرى، بل جاء في بداياته نابعًا من روح الثقافة العربية التي مجّدت الكلمة وعدّت البيان معيارًا للفصاحة والقيمة الأدبية.
ومن هنا، فإن تتبّع بدايات النقد عند العرب يُعدّ مدخلًا لفهم العقل العربي الجمالي، وكيفية انتقاله من الحسّ والذوق إلى النظرية والتحليل.
لقد عرف العرب في الجاهلية والإسلام المبكر شكلًا من أشكال التذوق الأدبي والنقد الفطري، ثم ما لبث أن ارتقى هذا التذوق مع حركة التدوين والوعي الحضاري في العصر العباسي إلى مستوى التنظير والتقعيد، مما مهّد لظهور النقد العربي الكلاسيكي في صوره المتقدمة عند قدامة بن جعفر، وابن طباطبا، وعبد القاهر الجرجاني، وغيرهم.
وسنحاول في هذا المقال تتبّع المراحل الأولى لتكوّن الوعي النقدي العربي، مبينين كيف انتقل من الذوق الفردي إلى النظرية الأدبية المنهجية.
أولًا: النقد بوصفه ذوقًا فطريًا في العصر الجاهلي:
لم يكن النقد في الجاهلية نشاطًا مستقلًّا أو مؤسّسًا على قواعد مكتوبة، بل كان فعلًا ثقافيًا عفويًا، نابعًا من تقدير العرب للكلمة الشعرية ووعيهم بقيمتها في بناء السمعة والمجد القبلي.
كان الشاعر آنذاك لسان قومه، وكانت القبائل تتباهى بشعرائها، وتحتفي بالمفاضلة بين القصائد في الأسواق الأدبية مثل سوق عكاظ وذي المجاز والمجنة.
في هذه الأسواق كانت المنافسات الشعرية ميدانًا طبيعيًا للنقد. كان الحُكّام من فحول الشعراء أو ذوي الذوق الرفيع يصدرون أحكامهم على النصوص من حيث جزالة الألفاظ، وسلامة التراكيب، ودقة التصوير، وصدق العاطفة.
وهذه الأحكام، وإن بدت فطرية وغير مؤسسة على مفاهيم نظرية، إلا أنها كانت تحمل نواة الحسّ النقدي العربي.
ويُروى أن النعمان بن المنذر كان يستدعي الشعراء وينصت إليهم ثم يفضل بعضهم على بعض، كما كان النابغة الذبياني يُحكّم في سوق عكاظ ويصدر أحكامًا دقيقة على الشعراء، إذ يقول للأعشى أو حسان أو الخنساء:
“لقد أحسنت في كذا وأخطأت في كذا”.
وهذه الملاحظات كانت تمثل إدراكًا مبكرًا لمفهوم الجودة في الشعر، وإن كان التعبير عنها يتم بلغة الذوق والتذوق لا بلغة المفهوم النقدي.
ومن اللافت أن النقد الجاهلي كان يعتمد على الذوق السليم والتجربة السمعية أكثر من التحليل العقلي. فالشاعر أو الناقد لا يستند إلى قواعد بل إلى إحساسه بالإيقاع والصورة والمعنى.
ومن هنا يمكن القول إن النقد في هذه المرحلة كان «نقدًا شفهيًا ذوقيًا»، يؤسس لمرحلة لاحقة من الوعي الجمالي المنظم.
ثانيًا: النقد في صدر الإسلام والعصر الأموي –
من الذوق إلى الوعي اللغوي
مع مجيء الإسلام، حدث تحول جوهري في مفهوم اللغة والبيان.
فقد أصبح القرآن الكريم هو النص الأعلى الذي شكّل معيار البلاغة والفصاحة، ووجه أنظار العرب إلى الإعجاز اللغوي، مما عمّق الحسّ النقدي عندهم.
صار المفسرون واللغويون والقراء يتأملون النص القرآني في ضوء مفاهيم البلاغة والتراكيب والمعاني، وهذا الوعي الجديد انعكس بطبيعة الحال على الشعر والنثر معًا.
وفي العصر الأموي، ومع ازدهار الخطابة والشعر السياسي، برزت الحاجة إلى تمييز الجيد من الرديء في القول، مما أعاد إحياء الذوق النقدي، ولكن ضمن وعي لغوي أكثر دقة.
فقد ظهرت ملاحظات نقدية على شعراء مثل جرير والفرزدق والأخطل، وكان النقاد يدرسون مفردات القوة والضعف في أساليبهم، ويقارنون بين طريقتهم وطريقة القدماء من شعراء الجاهلية.
كما ساهمت حلقات العلماء واللغويين في البصرة والكوفة في توجيه النقد نحو التحليل، إذ أصبحت مفاهيم مثل «الجزالة» و«الرقة» و«الطبع» و«الصنعة» جزءًا من الخطاب النقدي، وإن لم تُبلور بعد في شكل نظريات متكاملة.
ويمكن القول إن النقد في هذه المرحلة شهد تحولًا من الذوق الفردي إلى الوعي اللغوي التحليلي، وهو ما مهّد لنشوء المدارس النقدية فيما بعد.
ثالثًا: النقد في العصر العباسي – التأسيس للنظرية
شهد العصر العباسي أوج الازدهار الحضاري والفكري، ومعه بلغت الحركة النقدية العربية مرحلة النضج. فقد ظهرت مؤلفات نقدية مستقلة، وتحوّل النقد إلى علم له مصطلحاته ومناهجه. ويمكن تمييز ثلاث مراحل في هذا التحول:
١- مرحلة الملاحظات الفنية:
بدأت هذه المرحلة مع ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، حيث حاول أن يضع معايير لتقويم الشعر، فتكلم عن جودة المعنى وصدق العاطفة وسلامة الأسلوب. كان ابن قتيبة أول من ربط بين جودة الشعر وملاءمته للذوق العربي العام، معتمدًا على فكرة “الطبع” في مقابل “التكلف”، فأسس بذلك لمفهوم نقدي يتجاوز الانطباع إلى التفسير.
٢- مرحلة التنظير الجمالي:
ثم جاءت مرحلة قدامة بن جعفر بكتابه نقد الشعر، الذي يُعد أول محاولة لصياغة نظرية نقدية عربية تقوم على مفاهيم محددة مثل «اللفظ» و«المعنى» و«المطابقة» و«المناسبة».
وضع قدامة تعريفًا للشعر بأنه “قول موزون مقفى يدل على معنى”، فحدد بذلك عناصره الأساسية، وميز بين الشكل والمضمون. وقد مثّل هذا الكتاب نقلة نوعية في مسار النقد العربي، إذ انتقل من الذوق إلى النظر العقلي المنظم.
٣- مرحلة التحليل البلاغي:
تتجلى هذه المرحلة في أعمال عبد القاهر الجرجاني، الذي ارتقى بالنقد إلى مستوى النظرية البلاغية الكبرى. ففي كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، أسس الجرجاني لفكرة أن جمال النص يقوم على “النظم”، أي على العلاقات بين الألفاظ والمعاني، وليس على الألفاظ أو المعاني منفصلة.
بهذا الطرح انتقل النقد العربي إلى أفق فلسفي لغوي عميق، جمع بين الذوق والعقل، بين الجمالية والنسق، وهو ما جعل الجرجاني ذروة الفكر النقدي العربي الوسيط.
رابعًا: من النقد الذوقي إلى النقد النظري – ملامح التحول
إن انتقال النقد العربي من الذوق إلى النظرية لم يكن انتقالًا مفاجئًا، بل مسارًا متدرجًا تشكل عبر قرون. ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التحول في النقاط التالية:
١- التحول من المشافهة إلى التدوين:
كان النقد في الجاهلية شفويًا، يعتمد على الحفظ والسماع، ثم صار مكتوبًا في العصر العباسي، مما أتاح تنظيم الأفكار وتداولها علميًا.
٢- التحول من الانطباع إلى التحليل:
بدأ النقد بملاحظات انطباعية، ثم تطور إلى تحليل مبني على مفاهيم لغوية وبلاغية.
٣- التحول من الفردية إلى المنهج:
في البداية كان الناقد فردًا صاحب ذوق، أما في العصر العباسي فقد ظهرت المدارس والمناهج (كمدرسة اللفظ والمعنى، ومدرسة البيان والبديع).
٤- التحول من الحس الجمالي إلى النظرية الجمالية:
أصبح للنقد أدواته المفاهيمية ومصطلحاته، وأصبح قادرًا على تفسير الظاهرة الأدبية، لا مجرد الحكم عليها.
خامسًا: أثر التحول النقدي في الفكر العربي:
لم يكن هذا التطور مجرد ظاهرة أدبية، بل كان جزءًا من حركة فكرية واسعة في الثقافة العربية الإسلامية، حيث تفاعلت علوم البلاغة والنحو والمنطق والفلسفة لتنتج رؤية شاملة للنص. وقد ساهم هذا التفاعل في بناء عقل نقدي عربي يجمع بين الذوق الفني والعقل التحليلي.
فالجرجاني – مثلًا – تأثر بعلم النحو والمنطق في صياغة نظريته عن النظم، كما تأثر النقاد اللاحقون مثل حازم القرطاجني بالفكر الأرسطي في تنظيرهم للعمل الأدبي. وهذا يدل على أن النقد العربي لم يكن معزولًا عن البيئة الفكرية العامة، بل كان جزءًا من مشروع ثقافي شامل يسعى إلى فهم اللغة والجمال والمعنى.
يمكن القول في الختام إن بدايات النقد عند العرب القدماء كانت رحلة من الحس إلى الفكر، ومن الذوق إلى النظرية.
لقد بدأ العرب نقدهم بما جبلوا عليه من فطرة لغوية وذوق سليم، ثم ارتقى وعيهم الجمالي مع تبلور العلوم والآداب حتى صار النقد علمًا قائمًا على مفاهيم ومناهج.
وإن دراسة هذه الرحلة تكشف عن عمق التجربة النقدية العربية وأصالتها، وعن كونها نابعة من خصوصية ثقافية جعلت من الكلمة محور الوجود العربي ووسيلة التعبير عن قيمه ومعانيه العليا.
وهكذا نرى أن النقد العربي، وإن بدأ ذوقًا، فقد انتهى نظرية؛ وإن بدأ انفعالًا، فقد صار تحليلًا؛ وإن بدأ مشافهة، فقد غدا علمًا. ومن هذا التراث الزاخر يمكن للدارس المعاصر أن يستلهم أصول التفكير النقدي العربي، بوصفه تجربةً عقليةً وجماليةً أصيلة، لا تقل عمقًا عن نظيراتها في الثقافات الأخرى.