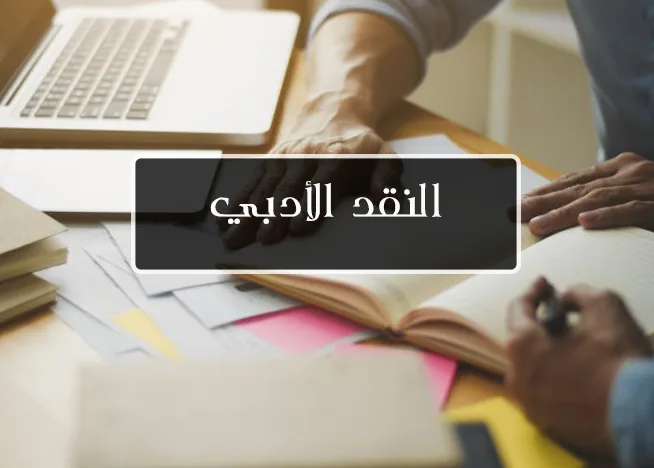البلاغة العربية بوصفها نظرية نقدية:من الجاحظ إلى الجرجاني
بقلم الناقد / أحمد المندراوي
تمثِّل البلاغة العربية في تراثنا النقدي ذلك الحقل المعرفي الذي تبلورت فيه المفاهيم النقدية قبل أن تُصاغ بأسمائها الفلسفية الحديثة، فهي ليست مجرد فنٍّ للبيان أو صنعة لغوية لتزيين القول، بل نسقٌ معرفيٌّ متكامل، تشكّلت في داخله رؤية العرب للغة، والجمال، ودلالة الخطاب، وموقع المتلقي، وأسس التأثير الفني.
ومن خلال تتبّع تطوّر البلاغة منذ الجاحظ، مرورًا بابن المعتز، وابن رشيق، وانتهاءً بعبد القاهر الجرجاني، تتضح معالم تحوّلها من فنون بيانية منفصلة إلى نظرية نقدية مكتملة تمتلك مفاهيمها، وغاياتها، وأدواتها التحليلية.
لقد كان لبواكير الفكر البلاغي العربي أثرٌ بالغ في بناء العقل النقدي القديم، إذ أسهمت النصوص التي نظرَت في البيان والإنشاء والمجاز في تأسيس الوعي بالعلاقة بين النظم والمعنى، وبين الأسلوب والأثر، وبين الإبداع والتلقي.
ويُعدّ هذا المقال محاولة لقراءة البلاغة العربية بوصفها مشروعًا نقديًا متكاملاً، يستند إلى رؤية جمالية عميقة، ويتعامل مع اللغة بوصفها ظاهرة فكرية وفنية في آنٍ واحد.
أولًا: البدايات – الجاحظ وتأسيس الحسّ البلاغي العقلي:
يُعدّ الجاحظ حجر الأساس في الانتقال من البلاغة بوصفها مهارة لغوية إلى البلاغة بوصفها فكرًا نقديًا.
ففي «البيان والتبيين» و«الحيوان» تتجلّى إرهاصات واضحة للوعي بالنص بوصفه خطابًا موجَّهًا لذائقة المتلقي، لا مجرد ألفاظ منسوجة.
١- الجاحظ ورؤية البلاغة العقلية:
يتعامل الجاحظ مع البلاغة على أنها نتاج تفاعل بين:
الفكرة – اللفظ – المقام – تقدير المتلقي
وهذا الرباعي يُؤسّس، بصورة غير مباشرة، لما سيُعرف لاحقًا بـ«نظرية النظم».
فهو يجعل البلاغة مرهونة بقدرة المتكلّم على أن يضع كل كلمة في موضعها المناسب، وفق سياق نفسي واجتماعي وثقافي.
٢- البلاغة والسياق:
يصرّح الجاحظ بأن البلاغة لا تستقيم إلا بمعرفة حال المخاطَب، وهنا يضع بذرة «جمالية التلقي» قبل أن تُصاغ كمفهوم حديث بقرون طويلة.
٣- نقد الجاحظ للزخرفة:
يرفض الجاحظ التكلّف اللفظي، ويعدّه انحرافًا عن الفن، لأن البلاغة – في نظره – ليست زخرفة بل أثر عقلي وجمالي في المتلقي.
وهذا الموقف كان أساسًا لتمييز البلاغة عن البديع بمفهومه اللفظي الضيق.
ثانيًا: ازدهار البديع وتحديات النقد:
مع ابن المعتز في «البديع»، انتقل مركز الثقل من التفكير في العلاقة بين اللفظ والمعنى، إلى حصر المحسنات اللفظية والمعنوية وتصنيفها.
وقد أسهم هذا الجهد في تطوير معرفة دقيقة بالأساليب، لكنه دفع البلاغة، لفترة، نحو «التقعيد الشكلي».
١- إيجابيات مدرسة البديع:
جمع وتسمية عدد كبير من الظواهر الأسلوبية.
لفت الانتباه إلى التنوع الفني للأدب العربي.
تأسيس منهج وصفي مبكر.
٢- سلبيات هذا الاتجاه:
التركيز الزائد على التحسين اللفظي.
ضعف النظر في بنية النص الكلية.
غياب التفكير الفلسفي في طبيعة الجمال اللغوي.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه كان مرحلة ضرورية أسهمت في نضج البلاغة، لأن النقد لا ينمو إلا عبر الحصر والتمييز.
ثالثًا: ابن رشيق ومحاولة إعادة التوازن بين المعنى واللفظ:
في «العمدة»، يظهر ابن رشيق ناقدًا يرفض هيمنة الزخرفة، مع احتفاظه بوعيه بمساحة البديع.
فهو يقدّم رؤية وسطى تؤكّد:
أن اللفظ وعاء للمعنى
وأن جودة الشعر مرتبطة بتناسبهما
وأن المبالغة في التزيين تُفسد الأثر الجمالي
١- المعنى هو الأصل:
يرى ابن رشيق أن البلاغة ليست في «اللفظ الفاخر» وحده، بل في مطابقة الكلام لمقتضى حال المتلقي، مما يعيدنا إلى الجاحظ، ويمهّد الطريق لعبد القاهر.
٢- البلاغة والسرقة الشعرية:
يفرد ابن رشيق فصولًا مهمة في تمييز التوليد والإبداع من التقليد والاستعادة، مما يؤسّس لوعي نقدي متقدم ينظر في بنية العلاقات بين النصوص.
رابعًا: عبد القاهر الجرجاني – اكتمال النظرية النقدية:
يمثّل عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) ذروة تطور البلاغة العربية.
فهو المنظّر الذي نقلها من عالم الملاحظات الجزئية إلى منظومة نقدية فلسفية ترتكز على:
نظرية النظم
علم المعاني
مفهوم المعنى الثاني
العلاقة بين الدلالة والتصوير
أثر المتلقي في اكتمال العملية البلاغية
١- نظرية النظم:
يرى الجرجاني أن الجمال اللغوي ليس في المفردات، بل في طريقة تأليفها.
اللفظ، في ذاته، لا يخلق الأثر؛ إنما علاقته بما قبله وبعده.
“النظم” هنا ليس مجرد تركيب نحوي، بل هو:
بناء دلالي – ترتيب نفسي – هندسة فكرية – انسجام إيحائي
وهذه الرؤية قريبة جدًا مما نسمّيه اليوم:
لسانيات النص – التداولية – علم الدلالة – بلاغة الخطاب
٢- بلاغة المعنى:
يفرّق الجرجاني بين «المعنى الأول» الظاهر، و«المعنى الثاني» الذي يتولّد من علاقات النص الداخلية.
وهذا التمييز هو اللبنة الأولى لنظرية «التأويل».
٣- المتلقي مركز العملية البلاغية:
يصرّح عبد القاهر، في أكثر من موضع، بأن الجمال لا يتحقق إلا في ذهن المتلقي.
إنه يرى البلاغة حدثًا مزدوجًا:
نص + عقل يُحسن التلقي = أثر بلاغي كامل
وبهذا يكون الجرجاني من أوائل مَن وضعوا الأساس لفكرة «جمالية التلقي» قبل المدارس الغربية الحديثة.
خامسًا: البلاغة كمنهج نقدي وليس مجرد فن لغوي:
من خلال تطورها، لم تعد البلاغة مجرد وصف للصور والمجازات، بل أصبحت:
١- مقتربًا نقديًا لفهم الأدب
٢- أداة لتحليل البنية العميقة للنص
٣- وسيلة للكشف عن آليات التأثير الجمالي
٤- منهجًا لتقييم جودة الشعر والنثر
وقد وظّفت البلاغة العربية مبادئ عقلية دقيقة، مثل:
المناسبة بين اللفظ والمعنى – انسجام الأجزاء
ملاءمة الكلام للمقام – مراعاة حال المخاطَب
التكثيف الدلالي – الانزياح اللغوي
كل ذلك يعكس رؤية فلسفية للجمال تُوازي ما ظهر لاحقًا في الغرب في البلاغة الجديدة.
سادسًا: الجمال بوصفه فكرًا – البعد الفلسفي في البلاغة العربية:
ربما يظن البعض أن البلاغة العربية بقيت سجينة اللفظ، لكن القراءة المتعمقة تُظهر أن النقاد العرب انشغلوا بأسئلة فلسفية جوهرية، منها:
ما علاقة اللغة بالفكر؟
كيف يتحول المعنى إلى صورة؟
ما سر تأثير الكلام؟
كيف ينتج النص معاني جديدة؟
ما دور المتلقي في تكوين الدلالة؟
ما الفرق بين الجمال الطبيعي والجمال الفني؟
هذه الأسئلة التي طرحها عبد القاهر مثلًا، تجد صداها اليوم في:
فلسفة اللغة – علوم التأويل – جماليات الفن – النقد الظاهراتي -النقد البنيوي
وهذا ما يجعل البلاغة العربية جزءًا من الفكر الإنساني العام، لا مجرد تراث محلي.
سابعًا: أثر البلاغة في تشكيل الذائقة النقدية العربية:
لا يمكن فهم النقد العربي القديم من دون فهم البلاغة، فقد أسهمت في:
١- صياغة معايير تقييم الشعر
٢- ترسيخ مفهوم الجودة الفنية
٣- تقنين استعمال المجاز
٤- تكوين حس نقدي لدى القرّاء والشعراء
٥- إنشاء لغة تحليلية دقيقة
ولولا الجهد البلاغي لما استطاع النقد العربي أن يبلغ ما بلغ من دقة وتماسك.
ثامنًا: البلاغة بين التراث والحداثة:
شهدت البلاغة في القرنين الأخيرين محاولات تحديث واسعة عبر:
ربطها بعلوم اللسانيات
إعادة قراءة عبد القاهر بنظريات التداولية
دمج البلاغة القديمة مع البلاغة الجديدة
توظيفها في تحليل الشعر المعاصر
وهذا التزاوج بين التراث والأدوات الحديثة مكّن البلاغة من الاحتفاظ بحيويتها باعتبارها منهجًا نقديًا قادرًا على تفسير النصوص القديمة والحديثة على السواء.
لقد أثبتت البلاغة العربية، منذ نشأتها مع الجاحظ، مرورًا بابن المعتز وابن رشيق، وانتهاءً بعبد القاهر، أنها ليست مجموعة من المحسنات اللفظية، بل هي نظرية نقدية تشتمل على رؤية جمالية وفلسفية للغة والفكر.
فهي تُعنى بالكيفية التي يترك بها النص أثره، وتكشف عن أسرار الإبداع، وتضع المتلقي في صلب العملية الفنية.
وإذا كان النقد العربي قد عُرف بتعدّد مناهجه، فإن البلاغة تبقى أعمق تلك المناهج وأكثرها رسوخًا، لأنها جمعت بين التحليل اللغوي، والتأويل الدلالي، والوعي بالفن، والتفكير الفلسفي في طبيعة الجمال.
بهذه القراءة، يتّضح أن البلاغة العربية ليست ماضيًا ندرسه، بل حاضرًا نقديًا يمكن أن نبني عليه ونطوّره، وأنها لا تزال قادرة على الإسهام في صياغة قراءات جديدة للأدب العربي قديمه وحديثه.