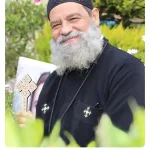قراءة في النقد الأدبي: النشأة، المعنى، والغاية”
في إطار مشروع معرفي يسعى إلى إعادة الاعتبار للنقد الأدبي بوصفه وعيًا جمالياً وفكريًا بالعالم، تأتي هذه السلسلة من المقالات التي تُنشر – حصريا – في جريدة CJ العربية لتقدّم للقارئ العربي قراءة معمّقة لمسيرة النقد الأدبي، منذ جذوره الأولى في التراث الإنساني والعربي، وصولًا إلى مدارسه الحديثة والمعاصرة.
تهدف هذه السلسلة إلى رصد التحوّلات الكبرى في مفهوم النقد ووظيفته، وتتبع مسار تطوره من الذوق الفردي إلى المنهج العلمي، مع محاولة الجمع بين الصرامة الأكاديمية والبيان الأدبي الرفيع، بما يجعلها صالحة للنشر الأكاديمي، وممتعة للقارئ المثقف في آنٍ واحد.
وإذ نفتتح هذه السلسلة بالمقال الأول الموسوم بـ
“النقد الأدبي: النشأة، المعنى، والغاية”
بقلم المستشار/ أحمد المندراوي
بين الذوق والمعرفة
منذ أن وُجد الأدب وُجدت الحاجة إلى من يقرأه قراءة مختلفة، تتجاوز اللذة الآنية إلى الفهم والتقويم والتمييز. فالنقد الأدبي ليس حديث النشأة، ولا وليد الصالونات أو الجامعات الحديثة، بل هو فعل إنساني أصيل نشأ مع أول محاولة لتذوق الكلمة الجميلة أو استنكار الزيف في القول. فكما يحتاج الإنسان إلى من يصنع الجمال، يحتاج كذلك إلى من يقرأه ويكشف مكنونه ويهديه إلى وعي ذاته.
إنّ الناقد، في جوهر دوره، ليس قاضيًا يطلق أحكامًا نهائية، بل هو قارئ مضاعف، يقرأ النص في ضوء العقل والذوق والوجدان، محاولًا فهم أسراره وبنيته وأثره في المتلقي. ومن هنا يمكن القول إنّ النقد هو الوجه الآخر للإبداع، أو هو الإبداع في صورته الفكرية التحليلية.
أولًا: مفهوم النقد الأدبي:
يُشتقّ لفظ “النقد” في العربية من الفعل نَقَدَ، أي ميّز الجيّد من الرديء في الدراهم، ومن هنا جاء المعنى المجازي الذي ينطبق على الأدب:
تمييز الجيد من الرديء في القول والفكر والصورة.
أمّا في اللغات الغربية، فالكلمة المقابلة هي Criticism المأخوذة من الأصل اليوناني Krinein، أي “التمييز والفصل والحكم”، وهي دلالة تقاطع ما بين المفهومين العربي والغربي.
ويُعرّف النقد الأدبي اصطلاحًا بأنه:
دراسة فنية تحليلية تقويمية للنص الأدبي قصد الكشف عن قيمته الجمالية والفكرية، وبيان مدى نجاحه في التعبير عن التجربة الإنسانية بلغة فنية.
ومن هذا المنطلق، لا يُعدّ النقد مجرّد إصدار حكم، بل هو منهج في القراءة، يعتمد على أدوات تحليلية ولغوية وفكرية للكشف عن العلاقات الداخلية للنص ودلالاته الخفية، بما يتجاوز الانطباع الشخصي إلى الفهم المنظم والعلمي.
ثانيًا: جذور النقد في الحضارات القديمة:
١- النقد عند اليونان:
بدأ النقد الأدبي في صورته النظرية مع الفلسفة اليونانية، وخاصة في كتاب فن الشعر لأرسطو الذي وضع أول تصور منهجي للفعل النقدي، إذ ربط بين الأدب والحياة عبر مفهوم المحاكاة (Mimesis)، وجعل الجمال نتاج التناسق والتوازن بين الشكل والمضمون.
ورأى أرسطو أنّ وظيفة الشعر ليست النقل الحرفي للواقع، بل محاكاة جوهره في صورة فنية تثير التطهير (Catharsis) في نفس المتلقي.
ومن هذا الفهم وُلدت فكرة المعايير الجمالية التي سادت النقد الكلاسيكي لقرون طويلة، حيث كان الناقد يُقوِّم النص بمقاييس ثابتة مستمدة من المنطق والفلسفة والأخلاق.
٢- النقد عند العرب القدماء:
أما في الثقافة العربية، فقد وُجد النقد منذ نشأة الشعر نفسه، حين كان العرب يجتمعون في الأسواق الأدبية كـ”عكاظ” و”ذي المجاز”، ويقوّمون القصائد بميزان الذوق واللغة.
وكان “النقد” في بداياته شفهيًّا انطباعيًّا يقوم على الفطرة، إلى أن ظهر النقد المكتوب في العصر العباسي، فصار علمًا له أصوله واصطلاحاته.
ومن أوائل النقاد العرب ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، وقدامة بن جعفر في نقد الشعر الذي حاول فيه وضع قواعد عقلية لتقويم الشعر، وعبد القاهر الجرجاني الذي أحدث ثورة فكرية حين جعل البلاغة والنقد قائمين على مبدأ النظم لا على اللفظ وحده.
لقد أدرك الجرجاني أن جمال النص ليس في المفردة المعزولة، بل في علاقتها بما حولها، أي في النظام التركيبي الذي ينسج المعنى، وهو بذلك سبق إلى ما يمكن أن نعدّه نواة البنيوية الحديثة.
ثالثًا: غاية النقد الأدبي ووظيفته:
النقد ليس غايته التهشيم أو الثناء، بل الفهم والتنوير.
إنّه محاولة لتجسير الهوة بين النص والمتلقي، وإضاءة المناطق المعتمة في العمل الأدبي.
ويمكن تلخيص غايات النقد في ثلاث وظائف أساسية:
١- الوظيفة الجمالية:
الكشف عن مكامن الجمال الفني في النص، من صورٍ وإيقاعٍ ولغةٍ وبناءٍ، وتبيين العلاقة بين الشكل والمضمون.
٢- الوظيفة المعرفية:
لأن الأدب، في جوهره، معرفة بالإنسان والعالم، فإنّ النقد يعمّق هذه المعرفة بتحليل الرموز والتجارب والرؤى.
٣- الوظيفة التربوية أو القيمية:
فالنقد يُسهم في تهذيب الذوق العام وتربية الحس الجمالي، وهو ما كان هدف النقاد القدامى في الشعر العربي.
وهكذا يصبح النقد وسيلة لتنوير الذهن وتربية الذوق، لا أداة لتقويض الإبداع.
رابعًا: من الذوق الفردي إلى المنهج العلمي:
في بداياته، كان النقد يعتمد على الذوق الفردي، أي انطباعات الناقد الشخصية.
غير أنّ التحولات الفكرية في القرنين التاسع عشر والعشرين جعلت النقد يتحول إلى منهج علمي قائم على التحليل البنيوي والنفسي والاجتماعي واللغوي.
فقد كان النقاد القدامى، مثل ابن رشيق والآمدي، يعتمدون على الذوق والموازنة، بينما جاء النقاد المحدثون — مثل طه حسين والعقاد — ليدمجوا الذوق بالتحليل المنهجي المستند إلى فلسفات الغرب الحديثة.
ولم يعد الناقد يكتفي بالحكم، بل صار يحلّل بنية النص الداخلية، ويبحث عن نظام العلامات والدلالات التي تُنتج المعنى.
ومن هنا نشأت مدارس نقدية متعددة: البنيوية، التفكيكية، النفسية، النسوية، الثقافية، وغيرها، وكلها تشترك في هدف واحد: قراءة النص قراءة عميقة تُنير جوانبه الخفية.
خامسًا: الناقد والمبدع — جدلية الخلق والقراءة:
العلاقة بين المبدع والناقد علاقة جدلية حساسة، فهي تجمع بين التوازي والاختلاف.
المبدع يخلق اللغة ليفجّر المعنى، والناقد يعيد قراءتها ليكشف ما وراءها.
المبدع يتحدّث بلغة الشعر، والناقد بلغة الفكر. ولهذا، يُقال إنّ الناقد شاعر بلغة أخرى.
لكنّ هذه العلاقة كثيرًا ما كانت متوترة عبر التاريخ:
فالمبدع يرى في الناقد قاضيًا متربصًا، بينما يرى الناقد نفسه مفسرًا أمينًا للنص.
والحقّ أن النص الأدبي لا يكتمل إلا بهما معًا:
فالنص يُولَد مرتين — مرة في لحظة الإبداع، ومرة في لحظة القراءة النقدية.
وقد عبّر رولان بارت عن ذلك بقوله: “موت المؤلف هو ميلاد القارئ”، أي أن سلطة المعنى تنتقل من المبدع إلى الناقد الذي يفعّل النص في وعي المتلقي.
سادسًا: النقد بوصفه قراءة ثانية للنص:
يُعدّ النقد الأدبي قراءة ثانية، أو قراءة على القراءة الأولى التي كتبها المبدع.
فإذا كان الإبداع هو القول الفني الأول، فإنّ النقد هو القول التحليلي الثاني، الذي يحوّل النص إلى موضوع للمعرفة.
ومن هنا، يصبح الناقد مؤوِّلًا، أي يعيد تشكيل المعنى في ضوء منهجه ووعيه وثقافته.
وقد تطور مفهوم النقد ليشمل أيضًا تحليل الخطابات الثقافية والاجتماعية، بحيث لم يعد مقصورًا على الشعر والرواية، بل تعدّاه إلى دراسة اللغة والإيديولوجيا والهوية.
وهذا ما جعل النقد الحديث يتحوّل من فن الحكم إلى علم التأويل، أي فهم النصوص لا على أنها كيانات مغلقة، بل كخطابات مفتوحة تتعدد قراءاتها بتعدد القراء.
سابعًا: النقد بين المنهج والحرية:
يواجه النقد الأدبي المعاصر سؤالًا محوريًا:
كيف يوازن بين المنهج العلمي الصارم وحرية الذوق والإبداع؟
فالنقد إذا جُرّد من الذوق صار ميكانيكيًا جامدًا، وإذا جُرّد من المنهج صار فوضويًا.
لذا لا بد من التوازن بين العلم والفن.
الناقد الحقّ هو من يجمع بين العين العالمة والقلب المرهف، فيكون قادرًا على تحليل البنية، وفي الوقت نفسه تذوّق الجمال.
ولعل هذا ما عبّر عنه إليوت حين قال: “النقد ليس علمًا، لكنه ليس انطباعًا محضًا”، أي أنه منطقة وسطى تجمع بين المعرفة والوجدان.
ثامنًا: نحو نقدٍ إنسانيٍّ جديد:
في عصرنا الراهن، ومع هيمنة التكنولوجيا وتغيّر الذائقة القرائية، يواجه النقد تحديات جديدة. فالنصوص الرقمية، والمحتوى البصري، والذكاء الاصطناعي، جميعها تستدعي نقدًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية.
لكن جوهر النقد يبقى واحدًا:
الإنصات إلى النص بوصفه كائنًا حيًّا يعبّر عن الإنسان في أبعاده كلها.
إننا بحاجة اليوم إلى نقدٍ إنسانيٍّ شمولي، لا يُقصي المناهج بل يوظّفها، ولا يُقدّس النظريات بل يقرأ بها النصوص قراءة واعية منفتحة.
فالنقد ليس بحثًا عن سلطة فكرية، بل بحث عن معنى الإنسان في اللغة والجمال.
النقد بوصفه وعيًا بالجمال والحقيقة:
إنّ النقد الأدبي في جوهره حوار بين الكلمة والعقل، بين التجربة والوعي، بين النص والوجود.
هو فعل حرية وفهم، لا فعل قيد وإلغاء.
من خلاله نحيا الأدب مرة ثانية، لا بوصفنا متلقين سلبيين، بل شركاء في الكشف والإبداع.
فإذا كان الشاعر/ الكاتب يضيء العالم بالكلمة، فإنّ الناقد يضيئها بالفكر، وإذا كان الأدب يحلم، فالنقد يُفسّر الحلم.
وعلى هذا النحو، يبقى النقد الأدبي جسرًا بين الفن والمعرفة، ووسيلة لارتقاء الذائقة الإنسانية، وإحدى أرقى صور الحوار بين الإنسان والعالم.
من كل ما سبق نستطيع القول:
إن النقد الأدبي ليس تابعًا للإبداع، بل مكمّل له.
فالإبداع يخلق الجمال، والنقد يكشفه ويؤوّله ويمنحه البقاء في الوعي الإنساني.
وكما أن الكلمة تخلِّد العاطفة، فإن النقد يُخلِّد الفكرة.
وإلى لقاء في المقال التالي.:
“بدايات النقد عند العرب القدماء: من الذوق إلى النظرية”